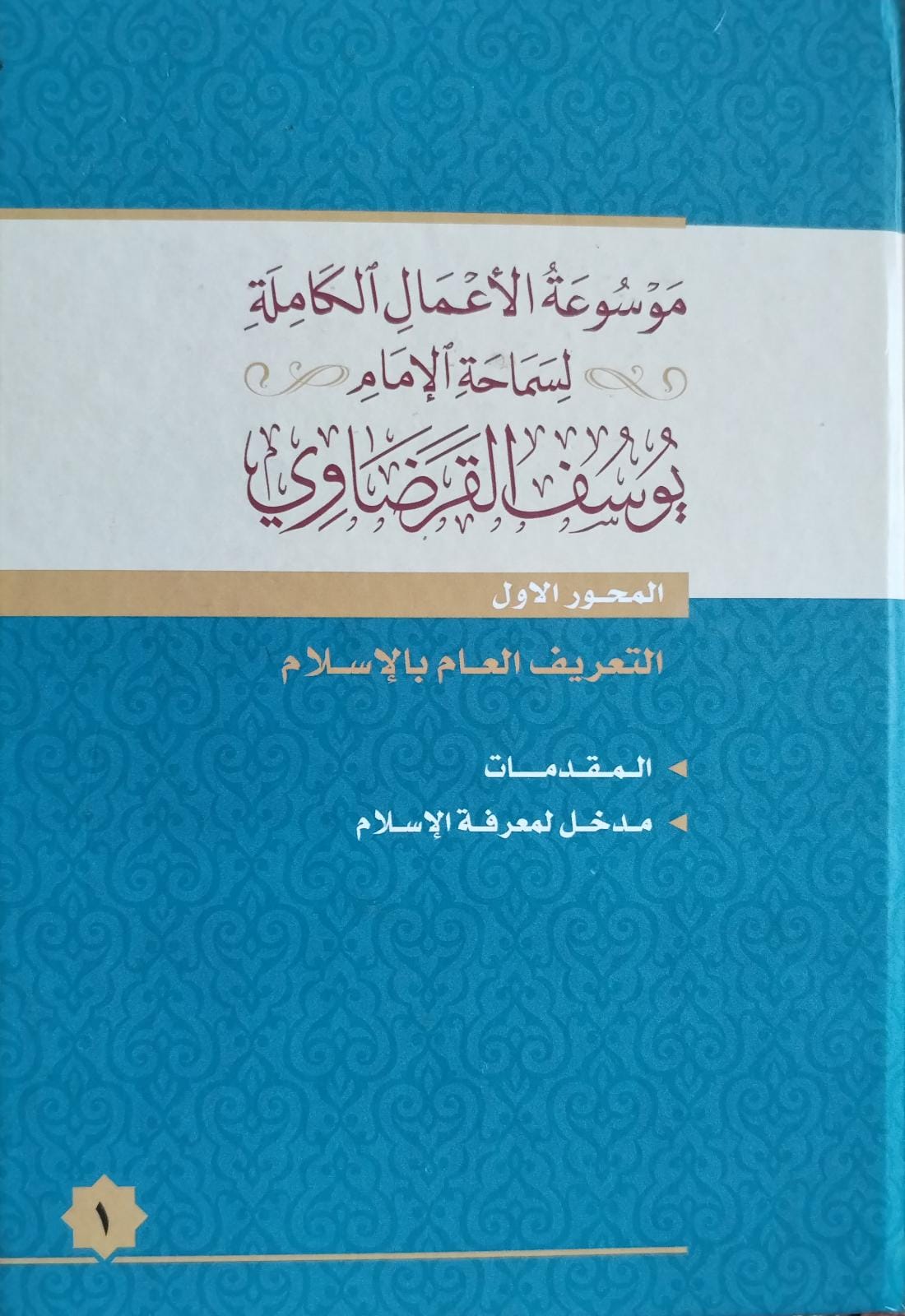- القرآن أرشدنا إلى فلسفة التنمية بنماذج واضحة متعددة
- نحتاج إلى التحلي بأخلاق الحضارة قبل طلب بعثتها
- الحركات الإسلامية تنشأ لمهام حضارية لا عصبية
- التنمية المفروضة اليوم علينا إما عشوائية أو قهرية
عرض: عصام فؤاد
بعد عقود من الافتتان وراء دعوات التغريب، تعالت صيحات الحكماء تنادي بمناهج التنمية الحقيقية المتوافقة مع العقيدة والقيم الخلقية لديننا ومجتمعاتنا؛ كي تكون السبيل إلى انبعاث حضاري جديد للأمة الإسلامية، تعيدها إلى مكانها ومكانتها بين الأمم والحضارات.
وقد تبع تلك الدعوات طرح عدة أسئلة مهمة، تبحث كيفية تحقيق التوازن بين الازدواج الحضاري الراهن المتمثل في الوافد الغربي علينا والذاتي المغرب بيننا؟، وكيف نوازن بين حاجتنا للآخر واستقلالنا الذاتي، وبين الانعزالية عن محيطنا والانفتاح بلا ضوابط؟ وما فلسفة البناء التي نحتاجها وتوازن بين طموحاتنا وإمكانياتنا؟.
وبأسلوبه العلمي وخبرته الحركية والتربوية ونظراته العميقة في الكتاب والسنة، يناقش د. سيد دسوقي حسن، أستاذ هندسة الطيران بجامعة القاهرة، تلك الأسئلة.. ويقدم حلولاً شافية لها، كما يطرح رؤيته لتحقيق التنمية والوصول إلى البعث الحضاري المطلوب.
ود. سيد دسوقي، من مواليد عام 1937م، وأحد خبراء هندسة الطيران في مصر والوطن الإسلامي، واشتهر بمشاركاته القوية في معالجة القضايا الحضارية والتنموية للأمة، بإصداره نحو 6 كتب وعشرات الدراسات والمقالات، لبحث أسئلة الحضارة والجواب عنها، غير المشاركة بالكثير من المؤتمرات في دول عدة.
المفهوم النحلي للتنمية
ويستفتح صفحات كتابه بإشارة إلى حال الوطن الإسلامي؛ حيث لا تخطط الشعوب لمستقبلها إلا قليلاً.. وهي إن خططت تضع هياكل ناقصة، ثم تسأل أين الداء؟!"، وداؤنا في تلك المنظومات الناقصة التي لا ترعى التكامل الحضاري للأمة، وتدور في حلقات مفرغة تبحث عن منطلقات للتنمية.
في حين أعطانا الله في آية واحدة الفلسفة الأساسية التي تلزمنا للتنمية، فيقول سبحانه: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(69)﴾ (النحل).
فقد ألهم الله النحل كيف يسكن ويأكل وكيف يكون حرًّا، ثم عقَّب المولى بتوضيح أن تلك الأمور الثلاثة متى تحققت يخرج من بطونها عسل مختلف ألوانه، فيه هدية للإنسانية وشفاء للناس، فما المانع أن يكون ذلك المفهوم النحلي للتنمية هو قواعد فلسفتنا للتنمية الشاملة؟.
لذا يرى د. دسوقي أن أساس التنمية هو توفير حق الشعوب في المأكل والمسكن والحرية، ثم ننتظر منهم الإبداع والاجتهاد في التنمية، ولو تم وضع عقبات تخالف ذلك ولا تراعي تلك الحقوق؛ فلا تسل عن تنمية أو نمو أو بقاء.
وإذا كانت الحكومات مطالبةً بوضع منظومات حاكمة ومحددة لعملية التنمية، فالمجال مفتوح للمشاركة والاجتهاد، كما فعل كاتبنا حين يعرض رؤيته للهيكل الحضاري للتنمية، ويجعل فلسفته هي: بقاء- نماء- سبق، وعناصره: الإمكانيات- التخطيط- التدريب- التعليم، ثم الوصول إلى النتيجة وتحقيقها.
وبحسب فلسفته للتنمية، فالخيارات أحد ثلاثة تتحرك لها الأمة، وهي تنمية البقاء أو النماء أو تنمية السبق، أو اختيار وتحديد نسبة من كل منهم، حسب الإمكانيات المتاحة، ثم رفع واقعنا وجميع معطياتنا المتاحة مع مراعاة الضوابط الأخلاقية، والتخطيط لعالم الأشياء بكل مكوناته؛ من مسكن ومأكل وملبس وغيرها، وبعدها تدريب البشرية على صناعة عالم أشيائها وإنتاجه، مع حرصه على أن يأتي التدريب قبل التعليم حتى يتحدد هدف التعليم؛ فلا يتم طحن الناس في نظم تعليمية لا تعرف هدفًا تنمويًّا، وبعدها نستطيع تحقيق عالم الأشياء والوصول إلى النتيجة.
وينتقد ما نشهده اليوم من تخطيط عشوائي للتنمية أو بواسطة المؤسسات الأجنبية التي تحرص على خلق فجوات بين حاجات الفرد وإمكانياته، وتخلق منه فردًا استهلاكيًّا أولاً وآخرًا؛ ما يتسبب في مولد عالم أشياء قهري وفق معطيات أجنبية، ويتبعه تنمية قهرية مسلوبة الإرادة، وتحقق فقط أهداف الخارج.
وأسوأ ما يتسبب فيه عالم الأشياء القهري هو حصر طاقات الأفراد في التطلع إلى رغباتهم وشهواتهم المادية، دون عمل حقيقي للإنتاج، ويحرك شعوب الريف نحو المدن بضغط إغراءاتها، فتكتظ الأخيرة وتتفشى البطالة، ويتواصل نمو العشوائيات، فيما لا يمكنك أن تسأل عن التوفيق بين السكن والعمل، فعمال جنوب المدينة يأتون من شمالها، وسكان الشرق يعملون في الغرب وهكذا، فنهدر آلاف الساعات، ونحرق الأطنان من الوقود في اللهاث وراء أعمالنا!.
ويضرب مثالاً بسيطًا حين نرجع الأمور إلى نصابها، ونخفف من حدة عالم الأشياء المقهورين به، فتتغير الكثافة السكانية، وتتوزع بالصورة الصحيحة؛ ما يساعد على توفير مسكن مناسب لكل فرد؛ يمكنه من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، عبر استخدامه كورشة عمل صغيرة للأمهات والأبناء، واستغلال مساحته في تربية الطيور والحيوانات وحتى الزراعة، والاستفادة من المخلفات التي ننفق ملايين الجنيهات للتخلص منها، في تلك الأعمال التنموية المبسطة.
التخطيط لعالم الأشياء
ويشدِّد الكاتب قبل التخطيط على تحديد مرحلة التنمية التي نتحرك بها؛ فهل هي تنمية البقاء، والتي نحاول فيها استغلال كل مواردنا؛ لتحقيق اكتفاء ذاتي وعيش كريم يوفِّر حاجاتنا الأساسية، وبهذه المرحلة يقل اعتمادنا على الميكنة ونستعوض عنها بالأيدي العاملة؟.
أم تنمية النماء؟، وفي هذه المرحلة يكون علينا الاستفادة من أخطاء الغرب، الذي كان من صور تنمية النماء عنده ازدياد سرطاني في عالم الأشياء، يضر بالإنسان؛ فنجعل مهمة المرحلة التحسين المستمر لآليات تنمية البقاء؛ بحيث تحتفظ بطهارة البيئة والتشغيل الأمثل لطاقات البشر مع الحد من تخليق عوالم أشياء ترفيهية قدر الإمكان، والسماح فقط بالتوسع في تلبية متطلبات عالم الأشياء الخاصة بالدفاع فقط.
أم تنمية السبق؟، وهي اختيار بعض الميادين لتحقيق سبق وتميز عالمي، خاصةً لو التفتنا إلى خريطتنا الإسلامية، وحقَّقنا منها التكامل المطلوب، فسنستطيع السبق في ميادين ومجالات عدة.
وبعد اختيار المرحلة نقوم بتوصيف للمنتج الذي نخطِّط له، مع مراعاة أهميته ومكانه بين قائمة أولوياتنا العملية والقومية والعالمية، وننظر إلى المواد المستخدمة في إنتاجه ونسبة المحلي فيها والمستورد، وطرائق إنتاجه ووسائله، مع تعظيم الطرق اليدوية، وتدريب الأيدي العاملة على صناعة المنتج، واستخدام وسائل التعليم المختلفة؛ لتوسيع قاعدة القادرين على إنتاجه، ويتم ذلك كله في منظومة فنية اقتصادية، تدرس جدوى الإنتاج، ويكون لديها القدرة على التسويق.
ويستند د. دسوقي في تخطيطه ذاك للتنمية على أصول القرآن التي توضِّح آياته دور الإنسان الواجب في إعمار الأرض، وجهده المطلوب لتحقيق النماء، فسورة (قريش) تبين دور الدولة في التفكير بنوع التنمية الراشدة للأمة، وإيلاف الناس (أي إلزامهم) على هذا النوع من التنمية، من خلال الإرشاد والتعليم والتدريب، مع حماية المنجزات التنموية من مكر الأعداء وتحقيق الأمن؛ ليتواصل بناء التنمية الحقة التي تراعي الوسطية، سواء بالإنتاج وفي الاستهلاك.
الأخلاق الحضارية
ويؤكد أنه قبل أن يبدأ النمو الحضاري فلا بد للأمة من ترسيخ بعض الأخلاقيات، وتخلية أبنائها من أخرى، ويجعل في مقدمة تلك الأخلاقيات الواجب التحلي بها، البر بالأوطان، وأقل هذا البر هو العمل لرفعة الوطن، وتيسير سبل العيش الكريم لأبنائه، وهذا يتنافى مع إيثار المصلحة الفردية على مصلحة البلاد، وتفضيل حتى الهجرة إلى الخارج؛ لنيل غير ذات الشوكة، والتخلي عن الواجب الوطني الذي يصنع خصوصية، لا تقضيها كفاية الآخرين.
والتأهب لفروض العين والكفاية، والجري وراء التخصصات التي تحتاجها الأمة لا وراء لقمة العيش، مع الوعي المستنير بخريطة الفروض الحضارية؛ لترتيب أولويات الأفراد والمجتمعات؛ فلا ننشغل بمهام تأتي في مؤخرة الواجبات والفروض الحضارية، ونكتفي بالحديث عن مؤامرات الاستعمار، دون الانشغال بكيفية إنتاج لقمة العيش؛ للاستغناء عن ذلك المستعمر قبل التحرك لمواجهته.
ثم الاستعلاء النفسي (الثقة في الله) المنبثق من عميق إيماننا بقيمنا الحضارية، وهو الأساس الذي نقاوم به القابلية للاستعمار، ونقهر به تلك القابلية في نفوسنا، ويسد ثغرات حب المال والجاه وغيرها مما يستغله أعوان ووكلاء الاستعمار؛ للتغلغل في مجتمعاتنا، وفتح العقول والقلوب أمام عبثة الفكر بها، قبل الترويج لمنتجاته.
ويرشد د. دسوقي إلى أهمية تحلي الأفراد بصفة التصديق بالحسنى، وهو أحد أضلاع المثلث مع العطاء والتقوى، فيقول سبحانه: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6)﴾ (الليل)، وهو الزاد الحقيقي للمؤمن الذي يلهمه الصبر على مشاق الطريق وصعوبات البناء، وكذلك الاتسام بالمحاولة الدائبة والفكر الأواب، بما يعين على تكرار المحاولة مع تعدد المراجعات لذلك الناتج البشري؛ حتى إن كنا سنبني حضارتنا على أساس من القرآن والسنة، فلا يمنع ذلك المراجعات المتكررة لذلك الاجتهاد البشري في البناء على أساس رباني.
والخلق السابع هو مزاوجة العلم بالأمانة، حتى ينطلق الناس إلى مجالات البناء، مزودين بسلاحي العلم والأمانة؛ التي تمنع فردًا من احتلال مكان يرى الحق فيه لغيره، وقد تدفعه في وقت آخر إلى طلب مكان يرى أنه أفضل من يقوم به ويؤدي مستحقاته، كما فعل سيدنا يوسف حين قال: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55)﴾ (يوسف).
التنمية الثقافية
ويتطرق الكتاب إلى نقطة غاية في الأهمية لقضية البعث الحضاري، وهي التنمية الثقافية، فيتساءل أولاً عن (ماهية الثقافة)، ويرى أنها مجموع المواقف العقلية لدى الإنسان تجاه ما يحيط به من علاقات وأحداث، وإذا كان البعض يعرِّف الثقافة بأنها جماع كل المواقف العقلية والعملية والنفسية للإنسان؛ بحيث إن ثقافة الفرد تجاه المرأة مثلاً تتحدد من مجموع مواقفه العقلية والنفسية والعملية نحوها، فكاتبنا يلتزم بتعريفه الأول، لافتًا إلى أنه كلما بعدت الثقافة عن الفطرة حدث الصراع والتضارب في مواقف الفرد العقلية والنفسية والعملية.
ويوضِّح أن الثقافة تختلف كثيرًا عن ذلك الحشو الذي نملأ به عقول أبنائنا، فتتكدس في عقله بدون وعي أو بصيرة، ولكي تؤدي دورها ومهامها؛ فلا بد من تخطيط واعٍ، يصبر على وضعه ألوف الطاقات والأفراد، ثم الترويج لذلك المخطط الثقافي الجديد بين المثقفين والفنانين والأدباء وغيرهم، حتى تخرج إبداعاتهم تخدم ذلك المخطط، وتحرِّك الأفراد لغاياته، بعيدًا عما نراه اليوم من إبداع، هو نتاج لثقافة علمانية غريبة عنا.
ويحدد دور الثقافة في الأمة بمهام سبعة هي: تقوية النسيج الاجتماعي، بالارتكاز على البعد الإيماني والمصلحي للأمة كلها، وإبراز نقاط الاتحاد والاتفاق، مع توهين روايات الصراع الشكلي التي يبرزها وينميها الاستعمار، ثم العون على تقبل المفاهيم التنموية بالتدريب والتعليم، وترويج ثقافة ترويحية تعين المكدود على تحمل كدح الحياة، وتعينه على صعوبات البناء.
وكذلك بيان الموقف الإسلامي من قضايا الحياة ابتداءً من الفرد والجماعة ثم الأمة وحتى الكون كله؛ فتتوحد وجهات النظر، ومن ثم مقاصد العمل، فتكون حركة الأمة جماعية لأهداف موحدة، مع كفالة الاختلاف في وجهات النظر، وتباين الآراء، في غير الأركان التي تقوم عليها التنمية.
وفي مقدمة مهام الدور الثقافي أيضًا شحذ الفعالية الروحية عند الفرد، حتى يصبح ذا همة حضارية وتوجه إصلاحي إسلامي، يسعى للبذل في أولويات أجندة التنمية، قبل السعي إلى مصلحته الشخصية، وتقوية المنهج العقلي الإسلامي عند المثقفين وصانعي القرار، بتربية الأجيال على المنهج العلمي الإسلامي، وأخيرًا بيان التحدي الحضاري الذي يواجه الأمة، وإسقاط ذلك على دور الفرد، حتى ينهض للتصدي لها.
أسلمة المعرفة
ويتناول الكتاب ما شهدته أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من موجة محاولات أسلمة المعارف والعلوم، وبدأت بالعلوم الإنسانية، ثم انتقلت في جهد- يراه كاتبنا غير موفق- إلى أسلمة العلوم الكونية، التي تتعامل مع الجزء المادي من الإنسان والبيئة، وتتمحور حول خلاصات التجارب، وتهيكلها بعض الفروض الغيبية، وفيه التجربة تكون محدودةً مادةً ووقتًا وآثارًا بحدود واضحة محكومة بدرجة معقولة.
أما العلوم الإنسانية فهي علوم التفاعل الإنساني مع الله والذات والجماعة والعالم في إطار بيئة محيطة وعالم غيبي قيمي، والتجربة فيها محدودة وقتًا ومادةً وآثارًا بحدود غير واضحة أو محكومة بدرجة كافية.. وتتغير تلك العلوم فعلاً باختلاف التجربة والقيم الموجودة في المجتمعات.
ويدعو د. دسوقي إلى إحاطة تلك المعارف والعلوم بسياج من القيم الإسلامية الحاكمة، حتى تكون مخرجات العمل منضبطة بقيمنا وثوابتنا الحضارية، مع الاهتمام فقط في مجالات أسلمة العلوم بالإنسانية، وعدم بذل جهد غير مطلوب في أسلمة العلوم الكونية التي بما فيه من حقائق تعتبر معارف إسلامية فعلاً.
البعث الحضاري والتحديات
ورغم معرفته الدقيقة بالواقع إلا أن كاتبنا يرى بوارق أمل عديدة تبشِّر بإمكانية البعث الحضاري من جديد، وهو يرسم الأدوار المنوطة بكل فريق للقيام بمهمته الحضارية، فالعلماء عليهم عدة واجبات في مستقبل الحضارة العربية الإسلامية، أولها دورهم في التنمية والسياسة، فيجب أن يضع علماؤنا من أصحاب الرؤى الواسعة مخطط التنمية الأمثل، والذي يراعي إمكانياتنا، ويتحرك وفق فلسفتنا في التنمية، كما يجب أن يشارك العلماء في صناعة القرار السياسي الذي يؤثر حتمًا على تخطيطهم للحاضر والمستقبل.
ويجب أن تتغير نُظم البحث العلمي في بلادنا وفق حاجتنا ومتطلباتنا، فتُيسر الاستفادة، واستغلال مواردنا؛ لتحقيق أعلى معدل للتنمية، ومع الغياب المتعمد من الإدارة المركزية عن تطوير البحث العلمي، فهنا يجب على الأثرياء إنفاق جزء من أموالهم في دعم بحوث العلماء وتطويرها في صالح الأمة كلها، وإذا كانت غالبية العلماء تمنعها الحياء أن تتواصل مع الأثرياء، فإن ذلك التواصل واجب على الطرفين؛ لتحقيق مصلحة أمر الله بها ونحتاجها جميعًا.
وإذا كان جيل العلماء الراهن قد سقط في دروب التنمية القهرية التي خططها الغرب لنا، فإن واجبهم هو إرشاد جيل العلماء الجديد والقادم إلى مثالب تجربتهم، فلا يقعون فيها، وتكون خطواتهم على درب التنمية القاصدة والهادفة لا العشوائية.
ومن ينظر إلى خريطة العالم الإسلامي سيجد اختلافًا كبيرًا في توزيع الموارد بها، وتباينًا بإمكانياتها البشرية والمادية والتقنية وغيرها، وحيث إن التوحد الواجب بعيد عنا الآن؛ فيجب على العلماء الصبر على المواقع ذات الاحتمال التقني، وتحمُّل شظف العيش فيها، حتى يحققوا التكامل المطلوب في خريطتنا الإسلامية، وكذلك عليهم تحقيق الوحدة من خلال اتحادات تجمع أرجاء الوطن الإسلامي؛ لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب، وتحقيق التنمية المثلى لكل قطر على حدة.
ومما لا شك فيه أن لرجال السياسة دورًا مهمًّا في التنمية العلمية؛ باتخاذ القرارات اللازمة وتهيئة الجو المناسب للبحث العلمي، بل وتوجيه العلماء إلى النشاط فيما تحتاجه الأمة، ويلبي متطلباتها.
فلسفة المنهج التجريبي
ويستشهد د. سيد دسوقي بقوله سبحانه: ﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (البقرة: من الآية 31)، فيقول أشعر أن الإنسان سيظل حدود علمه في التعرف على أسماء ما حوله دون النفاذ إلى ماهيتها، وكعلماء مسلمين لا بد أن تكون لنا فلسفة خاصة في التعامل مع العلوم التجريبية، ونضع فلسفة منهجنا التجريبي بالتوافق مع القواعد التي أرساها القرآن، ونبهتنا إليها الشريعة الإسلامية، لا سيما وأن المسلمين هم أول من وضع ذلك المنهج، قبل أن تصل إليه الحضارة الغربية وتنسبه إلى عالمهم "بيكون".
وكما يطالبنا القرآن باقتفاء الصراط المستقيم، فهو يعلمنا أن حركة عناصر الكون- المسيرة لا المخيرة- تتوخى الصراط المستقيم؛ لذا علينا ونحن ندرس طبيعة الكون كله أن نستغل ما نؤمن به من غيبيات للوصول إلى النتائج الأفضل، مع تطبيق منهجنا التجريبي والبحثي الذي يتعامل مع عناصر الكون على أنها صديقة تسبِّح معنا وتعبد معنا، لا غريم نود السيطرة عليه.
وأن خزائن ذلك الكون ليست ملك الجيل الحالي وحده، بل هي ملك لجميع الأجيال والذريَّات حتى قيام الساعة، وعليه نرفض أي استنزاف لمواردنا يحْرم المستقبل منها، كما نرفض أية تجارب تضر بالبيئة من حولنا، ويمتد ضررها ولو ظننًَا أن بها نفعًا، مع تأكيد أن عمليات الاستمتاع بالموارد يجب ألا يتبعها إفساد ولا طغيان.
التعليم والبطالة
حين نقصد التنمية فلا مناص عن ربطها بالمنظومة التعليمية، فيكون التعليم ومخرجاته مناسبين لمرحلة التنمية الراهنة، ونتخلص من مشكلات الواقع الذي أفرز لنا جهالاً يحملون شهادات، فلا علم ينفعون به، ولا عمل يؤدونه يفيدهم وينفع مجتمعاتهم.
وكما قسَّم د. دسوقي مراحل التنمية فهو يقسِّم مراحل التعليم؛ فيطلب نظام تعليم للبقاء يكون دوره الاستجابة لطلبات تلك المرحلة، ويتفاعل مع مكوناتها؛ لتقديم مخرجات قادرة على التفاعل السريع مع الموارد، وتتحرك للإنتاج والعمل اليدوي والحرفي، مع كفالة حق النابغين في منحات دراسية؛ للاستفادة من تفوقهم وعلمهم في دعم مرحلة البقاء والاستعداد لما بعدها بنظم تعليمية تناسب مرحلتي النماء والسبق.
ومن الوسائل المهمة لدعم التنمية والقضاء على البطالة اعتماد (المدرسة الشاملة وتقنية التعليم)، وفي هذه المدرسة نستطيع إضافة بعض المواد التي تعلِّم الطالب حرفًا يدويةً بسيطةً منذ الصغر، فيتعلم مثلاً في الابتدائية أعمال السباكة البسيطة، ويتواصل الأمر حتى يتعلم تركيب الشبكات المعقدة، وقد تكون الإضافات في المناطق الساحلية خاصة بطرق الصيد، أو في مناطق زراعية خاصة بتقنيات الزراعة وغيرها، فيصبح أي خريج يملك حرفةًَ يدويةً تكفيه عند الحاجة لتوفير مصاريفه ومصاريف أسرته، وتجعله منتجًا بالمجتمع.
كذلك على الدولة وضع خريطة بما تطلبه من عالم أشياء، وتوجِّه الأساتذة والباحثين إلى توفيره، فمثلاً نحن نحتاج مصاعد كهربائية، فنقوم باستيرادها كاملة أو يكتفي البعض بصنع الكبائن فقط، في حين أننا بقسم هندسة الطيران قمنا بتجربة فصنعنا جهازًا للتحكم بالمصاعد، كلفنا 300 جنيه فقط، في حين أن ما نستورده يكلفنا بين 7 و10 آلاف جنيه.
وبالمثل نستطيع- إذا أردنا- أن نغير واقع قطاعنا الصناعي والزراعي وغيره، بل والانتقال إلى تنمية كل مجالات التقنية؛ ما يوفر ملايين الوظائف التي تستوعب أيادينا العاملة وتقضي على البطالة.
الدولة الإسلامية ضرورة حضارية
والإسلام كعقيدة وشريعة وخلق وقيم يحتاج إلى دولة تحميه وتحمي المؤمنين، وتزود عنهم كما يزودون عنها، ويوضح د. دسوقي بأنه لا يقصد هنا الخلافة التاريخية، ولكن دولة عصرية تحقق مبادئ الإسلام وقيمه من خلال نظم عصرية تعيد الأخلاق إلى عوالم السياسة والاقتصاد والاجتماع، بعد أن جردتها الحضارة الغربية من كل خُلق.
وباستدلالات بسيطة يبرهن على ضرورة الدولة الإسلامية لمواجهة تحديات البناء أمام الفرد والجماعات، فتسخِّر لها كل الطاقات لاجتيازها والتغلب عليها، فلا يبني أفراد ويهدم آخرون، وتتناقض مساعي الجماعات أو على الأقل تختلف بما يغيب الهدف ويضيع المجهود.
والدولة المسلمة ليست فقط بحاجة إلى المسلمين وسكان أراضيها فقط، فتقيم بينهم العدل وتحقق الأمان والمساواة، بل يؤكد الكاتب أنها ضرورة للكون كله، فتحفظ النظام فيه، وتمنع الجبروت والطغيان، والناظر في التاريخ يجد أن العصور شهدت قيام الدول الكبرى جنبًا إلى جنب على مدار الأزمنة بما يمنع انفراد قوة واحدة بالأرض وطغيانها فيها، إلا في حالة الدولة الإسلامية التي سادت الأرض قرونًا متواصلةً، فلم تطغ أو تتجبر، بل حققت العدل وكانت ملاذًا للضعفاء من كل أرجاء الأرض.
ويوضح د. دسوقي أننا في سعينا لإقامة الدولة أو الخلافة الإسلامية لسنا مجبرين أو مصرين على نظام تاريخي معين، بل يمكننا باستغلال أدوات العصر أن نُنشئ نظمًا أكثر فاعلية من التي بناها أجدادنا وتحقق المطلوب.
ملاحظات حول الحركة الإسلامية
وبعد أن يحدد الكاتب تحدي الفرد لإعادة البعث الحضاري في الوصول إلى مرحلة اليقين بربه التي تدفعه إلى إيثار مشيئته، والعمل لصالح دينه وللأمة كلها، فهو يحدد دور الحركات والجماعات الإسلامية في أربع نقاط: شحذ الفعالية الروحية عند الأفراد بما يحقق ذلك اليقين ويدفع إلى العمل، واستيعاب علوم الغرب وتقنيته استيعابًا كاملاً، والقدرة على أسلمة نظم الحضارة المعاصرة أو إبداع بدائل إسلامية، وحماية المنجزات الحضارية.
وإذا كان القرآن هو معجزة الإسلام الخالدة، فقد أُوتي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه معجزةً أخرى، هي القدرة على الانبعاث الحضاري من وسط ذلك التخلف، وبناء أمة سادت الأمم في زمن يسير، رغم أن كل الظروف التي أحاطت بهم كانت أشق وأصعب مما يحيطنا.
ويفرق هنا بين التيار الإسلامي وأبنائه الذين هم كل من يحمل في نفسه وعقله شوقًا إلى الفكرة الإسلامية، وينتمي إلى المنهج الإسلامي ويود تطبيقه، وبين الحركات الإسلامية التي تحمل على عاتقها مواجهة يلفنا من مخططات معادية داخلية وخارجية؛ لتنفيذ مهام محددة تجسر الهوة بين الأمة والتحديات والعوائق التي تمنع انبعاثها الحضاري من جديد.
وقد تختلف توجهات الحركات الإسلامية الإصلاحية بين المجالات التربوية والحركية والتنموية، وحتى الفكرية والسياسية، إلا أنها تدفع جميعها- في حال الرؤية السديدة- إلى قبلة البعث الحضاري، فتشحذ الهمم وتعلي إيمانيات الأفراد، وتربي الكوادر، وتثري الفكر، وتخوض في السياسة، وتنمي المجتمع كله، والهدف ليس الوصول إلى حكم الدولة فقط، ولكن كفالة حق الأمة في بعث حضارتها، والالتجاء إليها والعيش في ظلالها.
ويطالب الجماعات بأن تحدد مهامها في البعث الحضاري بين شحذ الفعالية الروحية للأفراد ودعمهم للبناء، أو جماعات الإسلام القيمي المهتمة باستخراج القيم الإسلامية التي تحكم كل النظم الحياتية وما يحيط بها من حدود وضوابط، أو جماعات الإسلام المؤسسي التي تعمل على نظم مؤسسات الدولة في إطار القيم والضوابط الإسلامية.
وبخبرته الواسعة يدون ملاحظاته حول دور الحركة الإسلامية، فينبه أولاً إلى طبيعة التحدي الذي تواجهه الحركة، ويرى أنها تتحسن صنعًا إذا بصرت طبيعة التحدي الذي يواجهها، فقسمت جزيئاته، ووظفت طاقاتها وإمكانياتها لمواجهته، كما أن تقسيم التحدي الكبير إلى تحديات أصغر يفيد الحركة في زيادة الالتحام بالشارع حين تجد الحركة قواسم مشتركة واتفاقات مع غيرها في مواجهة تلك التحديات.
وحين يحذر من العنف والعنف المقابل، يحث الحركات الإسلامية على الوعي باتجاهات الفتنة التي يمكرها الاستعمار وأعوانه، واتجاه القابلية إلى الاستعمار التي مكنت لهذه الفتن داخلنا، بهدف منع انبعاثنا الحضاري وتشويه صورة الإسلام، وهي تستخدم لذلك وسائل سبعة، البطالة الظاهرة والباطنة التي تترك الطاقات بدون استغلال، فتتحرك بعشوائية وبعنف قد يصل إلى القتل، والتطفيف الاجتماعي؛ حيث تتغاضى كل الأطراف عن نواحي النقص عندها، وتهتم فقط بما عند الآخرين، وهو عكس اتجاه التربية الإسلامية.
كذلك تستغل غياب العلم الشرعي واضمحلال المؤسسة الدينية، ويتسبب ذلك في توجهات غير واعية لأفراد الحركات الإسلامية والتمسك بنقاط أقل شأنًا وأهميةً، وترك معالي الأمور، خاصةً مع غياب دور الأزهر الذي كان يحمل عبء توجيه وترشيد التدين والتبصير به.
والقراءة الخاطئة لأحداث التاريخ الإسلامي؛ حيث يتم ربط واقعة تاريخية وقعت في ظروف مغايرة بواقعنا الحالي، فلا نستفيد من درس الحدث ولا نفهم طبيعة واقعنا الراهن، والشعور بضياع الهامش الإصلاحي في الدولة، وعدم رؤية الضغط الاستعماري؛ ما قد يدفع الناس إلى حلول غير مأمونة العواقب، بل قد يلجأ كثيرون إلى العنف كوسيلة للتغيير.
وتسييس شباب الجماعات الإصلاحية، وعدم دفعهم إلى أعمال تربوية تنموية في ظل عدم وضوح مقاصد المناهج التربوية إن وجدت، وأخيرًا غياب التشخيص الحضاري، فلا يكفي اكتشاف أننا مرضى ولكن يجب تشخيص المرض، وبيان العلاج اللازم لشفائه.
ويتطرق حديثه إلى الروحية الاجتماعية والطرق الصوفية والتي يراها في عناصر ثلاث: عبادة مكثفة تصل العبد بالله والزهد في متاع الدنيا، وعطاء بلا حدود للمجتمع، ويوضح أن المقبول من هذه الطرق الصوفية هو أن تجتمع حول شخص ترى فيه القدوة الحسنة، ولكن بهدف شحذ روحانياتهم بدافع التوجه إلى البناء في التنمية، وليس قصر الأمر على أباطيل وروايات عن إشراقات لأصحابها يتم توريثها لآخرين بدون وجه حق.
ويواصل شوق كاتبنا إلى الاتحاد البروز في نقاط الكتاب، فيدعو من جديد إلى عمل اتحاد للمراكز الفكرية الإسلامية؛ من أجل وضع إستراتيجية فكرية وترجمتها إلى مشاريع، وتكليف جهات مختلفة بتلك المشاريع بما يمكن من الاستفادة منها، مع عنصرة المشاريع ذات الأولوية عنصرةً دقيقةً، وعمل ندوات حولها تهتم باستخلاص الجوانب العملية والتنفيذية التي تهم صانع القرار.
كما يقسم أنواع العمل الفكري بين إستراتيجي حركي يهتم بوسائل التغيير وتحديد أولويات التحرك، وفكر حضاري يحدد الموقف الحضاري والتحديات الراهنة، وآخر سياسي يعني بالموقف السياسي وبرامجه وكيفية صناعة القرار، وفكر اجتماعي وآخر قيمي وفكر تربوي أو تنموي، مع ضرورة التنسيق بين تلك المراكز لتحقيق الأهداف والغايات.
الإسلام والمواطنة
ومع تنامي الحديث في الفترات الأخيرة عن معنى المواطنة وحقوقها وواجباتها، يبرز د. سيد دسوقي استقرار الفكر الإسلامي على حرية الناس في الاعتقاد وكفالة حقهم في معاملاتهم الشخصية المبنية على معتقداتهم، مع التزامهم بمعاملات الأغلبية وقوانين الدولة.
بل إن الإسلام يتفوق على أفضل الديمقراطيات الحديثة في كفالة حق الأقلية في ترتيب خاص لعلاقاتهم ومعاملاتهم المنبثقة عن عقيدتهم، مثل الزواج والنسك والشعائر الدينية، وحتى لو طلبت الأقلية الامتناع عن الدفاع عن الوطن بدافع عقدي، فمن حقها ذلك مقابل دفع الجزية.
ويوضح أن الإسلام يفتح آفاقًا رحبةً للمشاركة أمام المواطن، بإعطائه حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مجال أمامه، والنصيحة للصغير والكبير وحتى الرئيس، وحق المشاركة التنموية ومناقشة كل أمور الدولة، والتعرف على خططها وأعمالها وأهدافها المستقبلية، مع ترسيخ مبدأ المساواة بين الجميع، وقد شهد التاريخ للخلافة الإسلامية بكفالتها تلك الحقوق وغيرها.